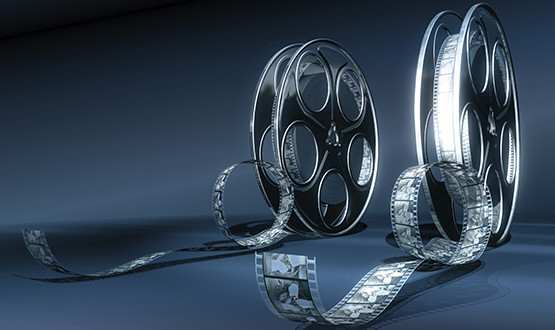يختتم مهرجان القاهرة دورته الثامنة والثلاثين هذا المساء بحفل توزيع الجوائز الذي يجري في دار الاوبرا. طوال عشرة أيام متتالية عرضت التظاهرة السينمائية الأشهر في العاصمة المصرية مجموعة أفلام من دول العالم والمنطقة، في رغبة واضحة لمغازلة الجمهور المحلي بعناوين لا يستطيع مشاهدتها إلا هنا. في إنتظار مقال مفصّل عمّا تميزت به هذه الدورة، نستعرض في الآتي بعض الأفلام التي استعادها “القاهرة السينمائي”.
“فقط نهاية العالم” للمخرج الكندي الشاب كزافييه دولان، ابن السابعة والعشرين، يأتينا بفيلم جديد عُرض في مسابقة كانّ ويعيد عرضه مهرجان القاهرة. البصمة جاهزة منذ اللقطة الافتتاحية، أجواء وتمثيلاً وإخراجاً وحوارات. دولان مخرج ينضج على مرأى منا. موهبته لم تعد تحتاج إلى نقاش. المشكلة هنا أنّه يقدّم فيلماً خارج الزمن و”متعباً”، وليس المقصود بالتعب الإرهاق الذهني الذي يهدف إلى إحاطة المُشاهد بكلّ ما تعانيه الشخصيات على الصعيد النفسي. فالفيلم مقتبس من مسرحية لجان لوك لاغارس (1957 – 1995) وضعها قبل خمس سنوات من موته بالسيدا. وهذا يعني اننا أمام مسرح مصوّر إلى حدّ ما، حيث الحوادث تتحرّك داخل فضاء مقفل، وإن حاول دولان الخروج منه عبر بعض لقطات التهوئة، إلا أنّ المحاولات الخجولة لم تنتشله من سمته الممسرحة الطاغية جداً.
ميزة هذا فيلم تمثيلية في المقام الأول: فنسان كاسيل وليا سايدو أولاً (في واحد من أفضل أدوارهما)، وماريون كوتيار وغاسبار اولييل وناتالي باي ثانياً. قائمة ممثلين كهذه، تضمن وحدها فيلماً بأداءات رصينة، ولكل ممثل خاصيته. ثمة أيضاً الإخراج وهو الميزة الرقم 2 هنا. في فيلمه السادس (بدأ العمل في نهاية العقد الماضي)، اختار الـ”وندر بوي” الكندي ممثلين فرنسيين يتكلمون الفرنسية. وداعاً للكنة الكيبيكية الثقيلة على السمع.
الفيلم عن كاتب مصاب بمرض قاتل (السيدا؟)، يعود إلى عائلته التي تقطن الريف بعد 12 سنة غياباً عنها، ليخبر أفرادها عن موته القريب. عندما نقول “ليخبر”، نجدنا نبالغ ربما في استعمال الكلمة، ذلك أنّه رغم الأحاديث الطويلة والمتداخلة التي يتشبع بها الفيلم، ليس ثمة ما يشير بوضوح الى المرض ولا إلى كلّ هذا الموت المعلن! انها لغة الإيحاءات والمسكوت عنه. مواضيع كالمثلية كانت تمزّق العائلات سابقاً، تبدو عادية اليوم، بل صارت تنتمي إلى زمن ولّى. فشل التواصل إحدى التيمات الرئيسية. فنحن سندور طوال ساعتين حول مسألة الموت هذه، من دون أن يتجرأ أحدهم حتى على لفظ اسمه.
لا أحد يصوّر الحيوانات كما يفعل أمير كوستوريتسا. هذا ما ندركه مرة جديدة بعد مشاهدة فيلم “على طريق الحليب” لأمير كوستوريتسا، المعروض سابقاً في مهرجان البندقية والمستعاد اليوم في القاهرة. مذ غاب المعلم الصربي عن السينما الروائية لتسع سنوات خلت، ونحن لم نشاهد فيلماً يحتفي بالحيوان بهذا القدر. فالدجاج والحمير والخراف والزواحف والدببة، جزء لا يتجزأ من قبيلته السينمائية. الفيلم مقتبس من ثلاث قصص حقيقية، استغرق إنجازه نحو أربع سنوات. أضف أنّ أحداً لا يوظّف الحيوان بهذا الشكل الظريف كما يفعل هو. باختصار، لن تتسنّى يومياً مشاهدة فيلم يتحوّل فيه الخروف انتحارياً بحزام ناسف أو أفعى تتذوّق الحليب. مخرج “أندرغرواند” صاحب مخيّلة خصبة تحمله إلى البعيد جداً. يقدّم كوستوريتسا فيلماً يشبهه ويشبه عوالمه التي اعتدنا عليها؛ نوع من الواقعية السحرية في أبهى تجلياتها. إنه كالسمكة، يحتاج إلى البقاء في المياه. نحن الذين عشقنا أفلامه حتى “قطّ أسود، قطّ أبيض” (1998)، وإلى حدّ ما “الحياة معجزة” (2004)، نجد في “على طريق الحليب”، كلّ مكوّنات سينما كوستوريتسا وتفاصيلها، من الموسيقى إلى الشخصيات الثانوية فالـ”بورلسك”، وتلك التيمات الكونية المنبثقة من المحلية. ثمة أيضاً الشريط الصوتي الغني جداً: صوت المروحيات والطيران والقنابل والحيوانات. ترافق هذا كله موسيقى تصويرية صاخبة من تأليف ستريبور كوستوريتسا، ابن المخرج الذي يخلف غوران بريغوفيتش بعد انتهاء العمل بينهما بسبب إشكال.
هذه المرة الأولى يمثّل فيها كوستوريتسا في فيلم من إخراجه، ويمكن القول إنه يتدبّر أمره جيداً قبالة الكاميرا وخلفها. الحوادث تجري خلال حرب البلقان، لا تفاصيل حربية، فهي ليست سوى خلفية تُمسك الحوادث وذريعة ليُمرّر كوستوريتسا بعض مواقفه السياسية التي لا وزن لها ولا تستحق التوقّف عندها من فرط هزالتها وقلة الأهمية التي يمنحها. الفيلم ليس عن الحرب بل عمّا بعدها. روعة الطبيعة والمساحات الخضراء لا تحجب، يا للأسف، النار والحديد. في هذا الديكور، تتبلور علاقة كيمياء بورلسكية على طريقة كوستوريتسا بين صديقنا الذي ينقل الحليب ولاجئة صربية إيطالية تهرب من ماضيها ومن جنرال بريطاني يطاردها. هذه اللاجئة تضطلع بدورها مونيكا بيللوتشي، ويعود الفضل إلى المخرج في بعض “الشرشحة” المحبّبة التي يُلحقها بالممثلة الايطالية عبر جعلها تركض خلفه بمستوعب حليب أو تنام بين قطيع من الخراف أو تخيط له أذنه المصابة التي طارت من مكانها. في المقابل، فإنه يجعلها تغنّي وتبكي؛ فعلان لم يسبق لها تأديتهما في حياتها المهنية.
يعود المخرج والناشط الأميركي مايكل مور إلى الواجهة، بعد غياب ستّ سنوات، ليقدّم فيلماً مستفزاً سمّاه “أين الاجتياح التالي.” (مع نقطة في آخر العنوان)، في إشارة إلى الغزوات والحروب الأميركية من فيتنام الى العراق فأفغانستان وأماكن كثيرة أخرى كرّست غطرسة الدولة العظمى على شعوب الأرض. الفيلم الذي انطلق من برلين واستعاده مهرجان القاهرة، ينطوي على كمية هائلة من التهريج، خلاصة النظرة التبسيطية السطحية الساذجة التي يلقيها على أوروبا وناسها وقوانينها ونمط العيش فيها. يصوّر مور كمَن يذهب في رحلة سياحية، الشنطة على ظهره والكاميرا في جيبه، غزوة أوروبا لاستلهام أفكار جديدة تجعل حياة الأميركيين أفضل. ليس جديداً عليه معالجة القضايا الداخلية لبلده بهذه الطريقة الضحلة، واضعاً نفسه في وسطها، علماً أنّه من الصعب فهم ما يشدّنا إليه في كلّ مرة. مثلما يصعب فهم نوعية الجمهور الذي يتوجه إليه هذا المشاكس. لكن، الفائز بـ”السعفة الذهب” عن “فاهرنهايت 9/11” يذهب هذه المرة أبعد من المرات الماضية، فيقدّم واحداً من أكثر أفلام المهرجان سطحية، أثار عرضه للصحافة أطناناً من الضحك، من ذلك الضحك الذي لا يكون دائماً بسبب الطرافة.
ينطلق مور في “مهمة” تحمله من الولايات المتحدة، الدولة التي كشف الكثير من عورتها، إلى أوروبا. وما أدراك ما أوروبا بالنسبة إلى الأميركي المتوسط الذي يضطلع مور بدوره تقريباً، متظاهراً بأنّه يجهل الكثير عن قارة “كلّ شيء فيها على ما يرام”، بحسب الفيلم. كلّ شيء “ملعوب” في الفيلم ليبدو هزلياً، وهو في كل حال لا صلة له بالوثائقي. يكتشف مور، يا للمفاجأة، أنّ بعض القوانين التي يطبّقها الأوروبيون في بلدانهم، أميركية الأصل. فيغرس العلم المرصّع بالنجوم ساخراً من فكرة الاحتلال ورغبة منه في تصدير القانون المنشود الى أميركا. ثم يمضي. وهكذا مرّات ومرّات.
فيلم آخر انطلق من برلين، حيث فاز قبل سنتين بـ”الدب الذهب”، يعرضه القاهرة: “فحم أسود، ثلج رقيق” لدياو ينان. تجري الحوادث في شمال الصين وتتمحور على شرطي يُصرف من عمله بعد مقتل زميلين له خلال عملية غير ناجحة للقبض على مطلوب، فيضطر الى العمل كحارس في مصنع. بعد خمس سنوات، تقع سلسلة من الجرائم، ما يدفع ببطلنا زانغ الى العودة، ويتولى التحقيق على عاتقه الخاص هذه المرة، قبل ان يكتشف ان كل الجرائم تصبّ عند فتاة تعمل في مغسلة. سيُغرم بها فوراً. هذا ثالث فيلم لينان الذي لفت مع “قطار الليل” (كانّ- 2007)، وهو غوص في عالم الجريمة والسواد والليل الحالك مع شخصيات تزجّ بنا في كلاسيكيات السينما البوليسية.
الفيلم ممعن في العنف النفسي والتجسيدي على طريقة السينما الآسيوية. يعرف ينان كيف ينقل حال المجتمع الصيني، وفي سعيه لإظهار المدينة والتباساتها، يقترب الى ذكاء جيا زانغي. نحن هنا في صين باردة، شتوية، شهوانية، منزوعة الألوان، يسيطر عليها نوع من الغشاء يمنع الرؤية الجيدة ويدفع المحبط الى الانتحار. هذه صينٌ حطّمتها الشيوعية وسحقتها الليبيرالية. غوصٌ بديع في هذا القعر، يزيده جمالاً الاخراج الواضح والمتزن الذي يضعه ينان، بحيث لا يهبط ايقاع الفيلم ولو للحظة.
هوفيك حبشيان
النهار


 الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان