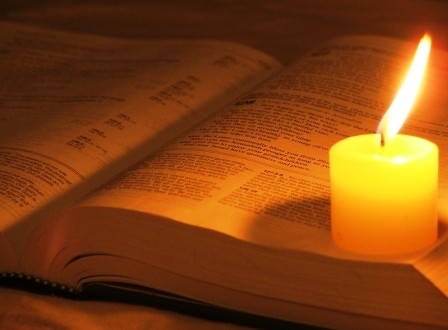الأنبا كريكور أوغسطينوس كوسا
حوّل مجيء يسوع المسيح إلى العالم ، مجرى التاريخ ، وردّ للإنسانية رونقها الأصلي بعدما شوّهتها الخطيئة . فلا نستطيع القول، أن تجسّد المسيح وميلاده وموته وقيامته كانت مجازفة شخصية قام بها ، ولا قيمة لها خارج نطاق زمانها ومكانها ، ولا تأثير لها على الإنسان عبر الأجيال . بل كانت حياته كلّها على الأرض ، تصميماً إلهياً ، تعطي طابعاً مميزاً لحياة كل إنسان ، وذلك بكامل حريّته واختياره للمخلّص ولمبادئه .
وردّ يسوع على سؤال نيقوديمس بمثال حيّة موسى النحاسية ، وذكّره بحادثة صحراء سيناء وشمسها اللاذعة ، عندما كان الشعب اليهودي عائداً إلى ارض الميعاد ، واعترضته صعوبات جمّة ومتاعب كثيرة ، كانت تُضعضع إيمانه بالله وإتكاله عليه . وبين هذه المحن ، محنة الحيات السامة التي فتكت بعدد كبير من اليهود . وكيف أمر الله موسى ليصنع حية من نحاس ويثبّتها ويرفعها على خشبة لكي يشاهدها الجميع . ومن ينظر إليها كان يشفى من لدغتها ولا يعود السم يؤثر عليه .
صورة الحية النحاسية هي رمز لخشبة الصليب وعليها المصلوب يسوع الفادي . من ينظر إليه ويؤمن به ويحيا إلى الأبد . ومن يرفض اللجوء إليه يخسر نفسه ويهلك في وحدته ويموت في يأسه .
والإنسان الذي يتكل على نفسه ، معرّض لخطر الخيبة والموت ، مهما ارتفع جاهه وعظمت أعماله وازدادت معرفته . ومهما تقدّم الطبّ ، فباستطاعته تلطيف الألم ، ولكنه لن يبطل الموت . فلولا تدخل الله في حيثيات يومياتنا لضاع معنى حياتنا ، وكنّا عرضةً لليأس القاتل الذي يرمي بنا ربما في بحبوحة الرجل الغني الذي اثمرت أرضه فانشرح صدره فقال لنفسه : “كُلي وتنعّمي يا نفسي لسنين طويلة ” . فقال له الرب : ” اليوم ستُطلب منك روحكٓ ” ، ” فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كلّه وخسِر نفسه ؟”.
ولكي يعيد الله الآب اعتبار الإنسان ، أرسل ابنه الوحيد إلى العالم : ” ما جئت لأحكم على العالم ، بل لإخلّص العالم ( يوحنا
١٢ : ٤٧ ) . فحياة يسوع وموته وقيامته المجيدة تعطي معنى لحياة الإنسان وموته وقيامته في منتهى الدهور . فهو الوسيط
الرحوم ، وعليه لم يتكّل الآب ليبعد عنه العذاب والشدّة والموت ، بل لكي لا يسمح للموت أن بجرّ الإنسان إلى الإضمحلال والتلاشي ، بل ليصبح عبوراً لحياة جديدة ولوجود من نوع آخر .
هذه الحياة ، ليست مكافأة ، ولا موعود بها لمستقبل بعيد ، بل هي حاضرة : ” قد اقترب منكم ملكوت الله ” ( لوقا ١٠ – ١١ ) ، وقد بدأنا نعيشه بالعمودية التي بها ولدنا ولادةً روحية ، متحررين من عبودية الخطيئة : ” ان الله الذي اقام الرب ، سيقيمنا نحن ايضاً بقدرته ” ( قورنتس الاولى ٦ : ١٤ ).
هذا ليس وعداً مبهماً ، ربما يحصل في الأزمنة الأخيرة ، بل هو وعد ، وعد به المؤمن في حياته الأرضية ، وقد تخلص بقوة القائم من بين الأموات ، وسيشاركه في ملكوته السماوي . إن الخلاص الذي وهبنا إياه ليس فقط غفراناً وتكفيراً لخطايانا الماضية ، بل
ايضاً هو كمال الخليقة ، بهاؤه وجهه الحقيقي الذي كوّنته يد الخالق المحب ، ويسوع هو القوّة التي غيّرت صورة العالم والإنسانية ،
يسوع هو الذي أتى إلى العالم ومنحه قوةً وعنفواناً جديدين ، وبثّ فيه روحاً جديدة فأحياه .
تأملنا اليوم ، في انجيل القديس يوحنا ( الفصل ٣ : ١ – ٢١ ) ، يحثنا لقبول وساطة يسوع وللإيمان بها في تاريخ البشرية ، بها
يتعلق مصير الإنسان الأبدي في النعيم او الجحيم . وهذه هي النعمة التي خصّنا بها المخلّص الفادي ، محبة بنا ، بدون أي
فضل لنا ، غيّٰر قبولنا به .
ورغم مجانيّة هذه النعمة ، يجرِّب الإنسان أن لا يصدّق الوعد ، وان لا يؤمن بالنعمة ، وأن يرفضها . فالمحبة غير مرغوب بها ، وغير مقبولة في عصرنا الحاضر المادي الأناني . ويحاول الإنسان إيجاد معنى لحياته في يومياته ودنياه . ويرفض النور ، مفضلاً الضلال في الظلام : ” استحبّ الناس الظلام على النور ، لأن اعمالهم سيئة ” ( يوحنا ٣ : ١٩ ) . يخافون من النور لأن أعمالهم ستنكشف للملأ وسيرغمون على تصحيح حياتهم وأعمالهم وتصرفاتهم .
ونحن ايضاً في حياتنا ، نفضّل الظلام على النور . نفكّر ونعمل هكذا وكأن يسوع المسيح لا وجود له . ولكن حقبات الحياة ، المليئة بالمفاجأت الأليمة وبالخيبات المرّة بفعل تألق الدنيويات المزيّف ، وتعلمنا أنه كما الصفر لا قيمة له لولا الرقم واحد بقربه ، هكذا لا يستطيع الإنسان لوحده أن يعمل شيئاً ، لولا المحرّك الإلهي فيه ومعه .
لنفتح قلوبنا بإيمان وطيد ، للتقدمة والمقدّم ، القربان والكاهن ، ولننظر إلى المصلوب ، كاليهود في صحراء سيناء ، لنخلص به ومعه،
هو الذي ينوّر طرقنا ، ويجدّد حياتنا ، ويحي أعمالنا بروح الإنجيل . وهكذا تظهر مشاريعنا كمشاريع الملكوت ونكون نحن مشاركين في بنائه وفي الخلق الجديد .
والإيمان بمحبة يسوع لنا ، والإقتناع بأننا محبوبون منه تعالى بنوع خاص ، والمحبة العامودية التي ترفعنا إليه تعالى لنحبه كألف وياء وجودنا ، والمحبة الأفقية ، التي تشمل اخوتنا البشر في قلوبنا ، لا بُدّ أن يكون صداهما ، ملكوت الله العادل والمحبّ ، حيث تكمن مصداقيتنا كمسيحيين حقيقيين ، وسعادتنا الكاملة في السماء ، مروراً في حياتنا الأرضية ، وادي الدموع والشقاء ، كأبناء الآب الخالق ، واخوة للإبن الفادي ، وهياكل حيّة للروح القدس .
زينيت


 الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان